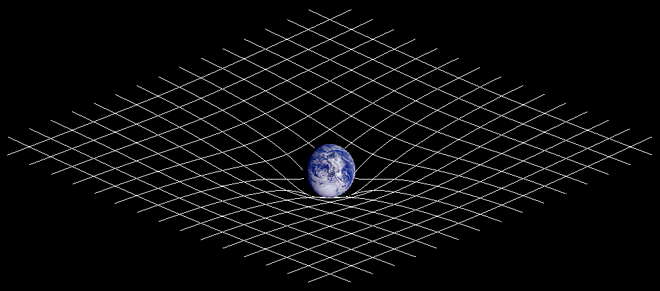قبل أن استمر في سلسلة التدوينات حول القوى الأربع الأساسية في الطبيعة،
فضلت أن أقدم هذه التدوينة عن العلم والطريقة العلمية. رأيت أن شرح معنى العلم
وطريقة اكتسابه والفائدة منه ستكون ضرورية قبل الاستمرار في شرح مفاهيمه. وهنا أحب
أن أوضح أن هذه المدونة معنية بمفاهيم العلوم والمعارف المكتسبة بالطريقة العلمية
(حسب ماهو مشروح في هذه التدوينة) ولا يدخل ضمن إطار عملها المعارف المكتسبة بطرق
أخرى.
ماهو العلم؟
حرفياً العلم يعني المعرفة. وفي وقتنا الحالي مصطلح "العلم"
يستخدم رسمياً للدلالة تحديداً على المعارف التي يتم اكتسابها بطريقة منظمة عن
طريق تطبيق الطريقة العلمية في اكتساب المعرفة (وهذه التعريف هو الذي تستخدمه هذه
المدونة). ولكننا نجده يستخدم بصفة عامة غير رسمية للدلالة على جميع أشكال المعارف
التي يتم اكتسابها وتعلمها، شاملاً أيضاً النشاطات المنظمة التي يقوم بها الإنسان
لاكتساب هذه المعارف واستخدامها وتطبيقها للتحكم في بئيته وماحوله وتغييرها بما يناسبه.
حسناً، إذا العلم يعني بصفة عامة المعرفة واكتسابها وتطبيقاتها، ولكن ما الذي يحفز
الإنسان للبحث عن المعرفة؟ أنه القدرة على التفكير! الإنسان له القدرة على التفكير
والتساؤل عن نفسه وماحوله ومحاولة فهم وتفسير الظواهر التي تحدث حوله ودوره فيها ومدى
تأثيرها عليه.
وهنا يأتي السؤال لماذا يفكر الإنسان؟ لإنه كائن ذكي يمتلك القدرة على
الوعي
الذاتي بنفسه وإدراك وجوده ويمتلك الإرادة الحرة. الوعي الذاتي يجعل لكل إنسان القدرة
على تمييز نفسه عن غيره (التفرد). الإرادة الحرة تعطيه القدرة على الاختيار بما يناسب
تفرده وأفكاره الذاتية التي تعكس فهمه لم حوله ومصالحه ورغباته. أما لماذا يمتلك
الإنسان هذه القدرات، فهذه قصة أخرى مرتبطة بكيفية تطور دماغ الإنسان ولا تتسع لها
هذه التدونية وسأحاول، أن تمكنت، أن أخصص لها تدوينة مستقبلاً.
هذه القدرات مكنت البشر من تطوير طريقة صوتية للتواصل فيما بينهما (لغات
محكية) ومن ثم تطوير طريقة لتسجل وحفظ ونقل هذه الأصوات (الكتابة). اللغة والكتابة
بدورها أعطتنا ميزة إمكانية حفظ خبراتنا ومعارفنا والعودة إليها
ومراجعتها وزيادتها ونقلها لباقي الناس في الحاضر وفي المستقبل ومكنت كل جيل من الإطلاع على معارف ما
قبله وزيادتها ونقلها لمن يأتي بعدها.
ما هي المعرفة التي يسعى الإنسان لاكتسابها؟
البعض يدرج طبيعة المعرفة التي يبحث عنها الإنسان ضمن ثلاثة مساعي إنسانية
أساسية: البحث عن الحقيقة، البحث عن الخير، والبحث عن الجمال. قبل تطور المنهج
العلمي والطرق التجريبية في اكتساب المعرفة، الفلسفة ربما كانت طريق العقل
الإنساني الأول للتفكير واكتساب المعرفة بطريقة عقلانية بعيداً عن الخرافة، وقد
انعكست هذه المساعي الإنسانية الثلاثة في ثلاثة مجالات أهتمت بها الفلسفة، كل واحد
منها يقابلها أحد المساعي الإنسانية الثلاثة. مسعى الحقيقة يقابله مجال الميتافيزيقيا،
ومسعى الخير يقابله مجال الأخلاقيات، ومسعى الجمال يقابله مجال الجماليات. كل مجال
من مجالات الفلسفة الثلاثة بدورها يقابلها فرع من فروع المعرفة والعلوم الحديثة،
الميتافيزيقيا يقابلها العلوم الطبيعية بكل أنواعها (فيزياء، أحياء، كيمياء، ...)،
الأخلاقيات تقابلها العلوم الاجتماعية (علم الاجتماع، الحقوق، العلوم السياسية، ...)،
والجماليات تقابلها الفنون والآداب (الرسم، النحت، الموسيقى، الشعر، ...).
 |
| المساعي الإنسانية المعرفية الثلاثة وما يقابلها في مجالات الفلسفة والعلوم الحديثة. |
“LIU, Y. 2003, The aesthetic and
the ethic dimensions of human factors and design, Ergonomics 13/14, 1293 –
1305.”
ما هي خصائص الطريقة العلمية في التفكير واكتساب المعرفة؟
الطريقة العلمية في اكتساب المعرفة تشمل ثلاث خطوات رئيسية:
- طرح تساؤل معين في الأغلب مبنى على مشاهدات أو ملاحظات لظواهر محددة.
- وضع فرضية محددة تحاول تعريف أو تفسير هذه الظاهرة وبطريقة يمكن قياسها وتكرارها، ويمكن استخدامها لتوقع مشاهدات أو حوادث هذه الظاهرة.
- اختبار الفرضية عن طريقة تجربتها ويتم جمع نتائج الاختبار وتحليلها وبناء على نتائج التحليل يتم قبول الفرضية أو عدم قبولها أو اقتراح تعديلات عليها وإعادة الاختبار.
كمثال بسيط، صاحب محل لملابس الرجال في مدينة ما لاحظ أن أغلب زبائنه من
البلدات المجاورة يطلبون دائماً سروايل ذات أحجام صغيرة؛ بينما أغلب زبائنه من نفس
المدينة يطلبون سروايل ذات أرقام كبيرة. وقد تساءل صاحب المحل بناء على ما لاحظه،
هل يعني هذا أن الرجال في مدينته أطول قامة من الرجال في البلدات المجاورة؟ هذا
مثال على الخطوة الأولى: طرح تساؤل مبني على ملاحظة أو مشاهدة لظاهرة معينة.
لتفسير هذه الظاهرة وضع صاحب المحل الفرضية التالية:" رجال مدينتي أطول
قامة من رجال البلدات المجاورة". هل يمكن قياس الظاهرة باستخدام هذه الفرضية؟ نعم يمكن قياس طول القامة للرجال. ويمكن تكرار ذلك أكثر من مرة، ويمكن باستخدام
هذه الفرضية توقع أن كل زبون جديد من المدينة سيكون في الأغلب أطول قامة من إي
زبون جديد من البلدات وسيطلب سروال بمقاس أكبر.
لاختبار فرضيته، قام صاحب المحل بإجراء تجربة تشمل قياس طول القامة لمجموعة
من رجال المدينة ومجموعة من رجال البلدات
(بعدد كافي يضمن الدقة وعدم الخطأ). وقرر أنه إذا وجد أن متوسط الفرق بين
طول قامة رجال المدينة أكبر بمقدار طول يساوي الفرق في مقاس واحد لحجم السراويل (تكون
عادة حوالي 5 سنتميتر) فإنه سيقبل الفرضية ويعتبرها تفسير مقبول للظاهرة التي
لاحظها. أما إذا كان أقل من ذلك فلا يمكنه قبول هذه الفرضية.
في حال قبول الفرضية بناء على النتائج والتحليل فقد يقود هذا إلى مزيد من التساؤلات والفرضيات، مثلاً في
مثال صاحب المحل السابق، سيكون التساؤل التالي لماذا رجال المدينة أطول قامة من
رجال البلدات؟ ويمكن وضع فرضية جديدة واختبارها (مثلاً غذاء رجال المدينة فترة
الطفولة كان أكثر تغذية من رجال البلدات أو الرعاية الصحية كانت أفضل .. أو غيرها
من الفرضيات). وعدم قبول الفرضية سيؤدي لتعديل الفرضية أو البحث عن تفسير وفرضية
جديدة. في مثالنا إذا لم تقبل الفرضية بناء على النتائج، فيمكن مثلاً تعديل
الفرضية بحيث تنطبق فقط على زبائن المحل من رجال المدينة والبلدات وليس كل الرجال
في المدينة والبلدة ويمكن تكرر التجربة على زبائن المحل فقط لاختبارها.
أيضاً حتى يتم قبول الفرضية بشكل نهائي يجب أن تكون قابلة لتكرار اختبارها
من قبل أطراف أخرى مع الوصول لنفس النتيجة في كل تكرار. في مثالنا السابق يجب أن
يستطيع طرف آخر (مثل أحد سكان البلدات مثلاً) أن يكرر التجربة بنفس الخطوات (قياس مجموعات
جديدة من رجال المدينة والبلدات) وأن يصل لنفس النتيجة.
أيضا في الطريقة العلمية لا توجد تفسيرات وحقائق مطلقة، بل تفسيرات مقبولة
وفق أفضل الأدلة العلمية المتوفرة حالياً (مثبتة بنتائج الاختبارات والتجارب).
وهذه التفسيرات قابلة للتغير إذا ظهرت أدلة جديدة تدعم تفسيرات جديدة أو تثبت عدم
دقة أو صحة التفسيرات الحالية. في مثالنا السابق، لو بعد فترة زمنية طويلة (جيل
كامل مثلاً) تم إعادة التجرية ووجد أن الفرق قد تقلص بين متوسط طول قامة رجال
المدينة والبلدات فلن تعود الفرضية الأولى مقبولة وهذا قد يقود إلى البحث عن فرضية
جديدة لتفسير الظاهرة أو الوصول إلى استنتاج أن الظاهرة نفسها قد تغيرت أو لم تعد
موجودة.
ماذا يجب أن يتوفر فيمن يستخدم الطريقة العلمية؟
من يعمل في مجال العلم والبحث العلمي ويطبق الطريقة العلمية يجب أن يتمتع
بالصفات التالية:
- فضولي وملاحظ جيد ودقيق وصبور وموضوعي، يستخدم التفكير المنطقي في تقييم ملاحظاته ومشاهداته.
- لا يقبل إي تفسير أو فرضية أو مقولة غير مدعومة بأدلة وبراهين كاملة مثبتة حتى لو جاءت هذه المقولة من جهة ذات سلطة أو اعتبرت تحصيل حاصل من قبل الأغلبية.
- ناقد لعمله وعمل غيره. حتى يتمكن من التأكد من صحة فرضياته وتفسيراته وصحة فرضيات وتفسيرات غيره.
- عنده القدرة على التخيل حتى يتمكن من وضع تفسيرات وفرضيات للظواهر المختلفة.
من أشهر الشخصيات العلمية التي تميزت بهذه الصفات غاليليو غاليلي (1564م –
1642 م) والذي يعتبره الكثيرون أحد أول المستخدمين للطريقة العلمية. فمثلاً
غاليليو لم يقبل الفكرة السائدة في عصره والمبنية على تفسيرات أرسطو (384 ق.م –
322 ق.م) حول سقوط الأجسام الحرة والتي تقول أن الأجسام الأثقل (أكبر كتلة) تسقط
أسرع من الأجسام الأخف (أقل كتلة)، وقام بتجربة ذلك بنفسه ليكتشف عدم صحة هذا
التفسير وأن كتلة الجسم لا تؤثر على سرعة سقوطه وأن كل الأجسام تسقط بنفس السرعة
بغض النظر عن كتلتها في حال عدم وجود مقاومة الهواء.
مثال آخر هو الحسن بن الهيثم (956 – 1040م). هو أيضاً يعتبر من أوائل من
استخدم الطريقة العلمية. فهو مثلاً لم يقبل التفسير السائد في عصره في أن العين
ترسل أشعة ضوئية نحو الأجسام حتى تستطيع الرؤية وقام بتجارب حتى وصل لتفسير أن
الرؤية تتم باستقبال العين لإنعكاس أشعة الضوء على الأجسام المختلفة.
ما هي الفائدة أو المنفعة من العلم؟
الفائدة الرئيسية والملموسة للعلم هي المساهمة في تطوير وتقدم المجتمع. هذا
المساهمة تأتي في صورة مباشرة و في صورة غير مباشرة. المباشرة تكون بتطبيق
واستخدام المكتسبات المعرفية على شكل تقنيات وتطبيقات ومنتجات تساعد في تحسين
تنظيم المجتمع وتركيبه، وتساعد في التحكم في البيئة والظروف الطبيعية المحيطة بما
يسهل ويحسن ظروف الحياة في المجتمع ويزيد في جودتها.
الغير مباشرة، تكون باستخدام جميع أفراد المجتمع لطريقة التفكير والعمل
الخاصة بالطريقة العلمية التي يستخدمها العلماء. مثلاً استخدام مثل هذه الطرق في
التفكير والعمل داخل مؤسسات الدولة سيزيد من فعالية وكفاءة أدءاها وتحسين وتطوير
خدماتها.
مع توفر شروط اقتصادية ملائمة، في إي مجتمع، إذا وصل عدد من يستخدمون
الطريقة العلمية في التفكير والعمل إلى عدد كافي (حجم حرج) فسيبدأ في إنتاج علم
ومعرفة مفيدة تؤدي أن يعمل المجتمع ككل بكفاءة وفعالية تؤدي بدورها إلى تحسن ظروف
وجودة الحياة في هذا المجتمع. وأيضاً، حتى يتحقق هذا، يجب أن يغطي ما ينتجه
المجتمع من معرفة كل مجالات المساعي الإنسانية المعرفية الثلاثة (العلوم الطبيعية،
العلوم الاجتماعية، الفنون والآداب). وأن يكون هناك توزان بين كمية ما ينتج من
معرفة في كل المجالات.
لرؤية ملخص للتدوينة في فيديو على اليوتيوب أنقر هنا
لرؤية ملخص للتدوينة في فيديو على اليوتيوب أنقر هنا